مساحة إعلانية

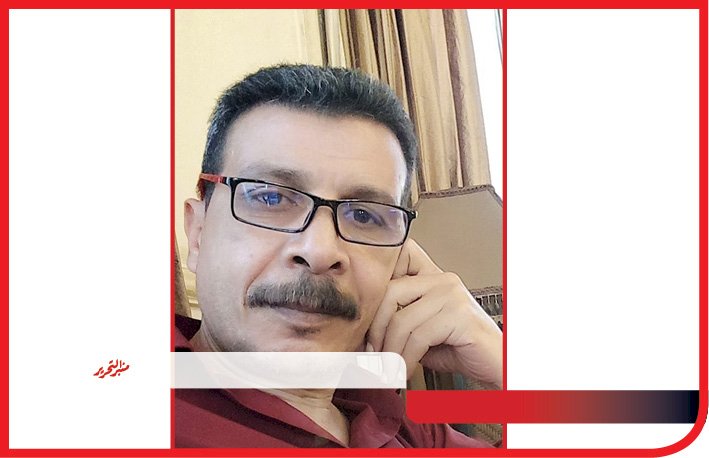

في مسرح الحكاية حين يجلس السارد ليروي، ينتظر القارئ على ضفة الحكاية الأخرى أن يحدث شيءٌ ما، أن تنهار جدران، أو تنشأ علاقة، أو تُسكب دماء، أو تُعقد صفقة، أو تُكسر القلوب، ولكن، ماذا إن لم يحدث شيء؟ لا صعود في وتيرة السرد، لا تصدّع في الجدار، لا خيانة، لا اعتراف، لا قتل، فقط صمتٌ طويل كأنّه يتأمل ظله، هنا، تتجلى أمامنا إشكالية عميقة ومُهملة، قلّما تصدّى لها النقاد أو الكتّاب، إشكالية "اللاحدث" في السرد الأدبي.
اللاحدث لا يعني الغياب التام للفعل أو النبض، إنما هو تلك الحالة السردية التي يظلّ فيها الزمن يدور بلا ذروة؛ تسير الشخصيات كأنّها تسير في مكانها، تتحرك ضمن دائرة، لا إلى الأمام ولا إلى الوراء، أشبه بمروحة سقف تدور ولا تُبرّد، هو سرد يتعمد الانكفاء على التفاصيل الصغيرة، على هامش الوجود، لا على حوافه الحادة.
وفي بعض التجارب السردية، لا يكون اللاحدث نقيصة، إنما هو اللبّ ذاته، ففي أعمال كتّاب كبار نرى أن الصمت، التأمل، وانتظار اللاشيء يصبحان فعلاً سرديًا مكثفًا، تصبح التفاصيل المُهملة، كصوت مغرفة الحساء وهي تلامس قعر الوعاء، أو نظرة امرأة إلى النافذة، أو تنهيدة شيخ أمام كتابٍ مغلق، أكثر وقعًا من ألف معركة، لكن، ما الثمن؟
إن القارئ المعاصر الذي تبرمج ذوقه البصري على إيقاع الصور المتلاحقة في السينما والمنصات الرقمية يدخل الرواية كما يدخل صالة السينما يبحث عن العقدة والحل، وعن الشخصيات التي تُولد ثم تنكسر ثم تنهض، غير أن "اللاحدث" يخذله، يقدّم له الخواء مغلفًا بالبذخ اللغوي، والتأمل المرهف، والبطء القاتل؛ فيبتعد، وهنا يكمن الإشكال، هل على السرد أن يُشبع شهية القارئ أم أن يُربكه؟ هل دوره الإمتاع أم الإدهاش؟
إن السرد الذي يسبح في "اللاحدث" يغامر بالخروج عن مألوف القارئ، ويراهن على قارئ آخر لا يريد من الرواية أن تحكي، إنما يريد أن تُقيم فيه، أن تتركه يتجوّل في ممرات المعنى بلا خريطة، مثل قصة تعيشها لا تقرأها.
وكما نعلم فإن القصة القصيرة بطبيعتها تحتاج إلى حدث، ولو كان طيفًا خافتًا، أما الرواية بفسحة امتدادها فهي الأكثر قابلية لاحتضان "اللاحدث" ليس بوصفه فراغًا بل باعتباره مناخًا روائيًا يتسلل في طيات النص، وفي المساحات البيضاء بين الجُمل، وفي التكرار المُتعمد لحالات يومية تُشكّل نسيجًا من السكون المضني الذي يُخفي تحته توترًا وجوديًا عظيمًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في أن "اللاحدث" إذا لم يكن محسوبًا، ومدعومًا بلغة قادرة على بث النبض في تفاصيل لا تنبض، فإنه يغدو خواءً فنيًا، لا تأملاً سرديًا، والنقاد نادرًا ما يتصدّون لإشكالية "اللاحدث"؛ لأن أدواتهم غالبًا ما تنحو باتجاه البحث عن البنية والعقدة والشخصية والدلالة؛ فيغيب عنهم هذا النوع من السرد الذي يعمل في الهامش، على الحد الفاصل بين الشعر والتأمل، بين المشهد واللاشيء، وهو بذلك يهرب من التصنيفات، ويؤسس لنفسه تيارًا هامسًا لا يُحب الأضواء، لكن ماذا لو كان هذا الهامش هو جوهر التجربة الإنسانية في زمننا ؟ زمن اللايقين، اللاوطن، اللازمن، اللاطمأنينة؟ ربما يكون "اللاحدث" هو أنقى تعبير عن هذا العصر، الذي تتكرر فيه الأيام دون جدوى، إننا حين نكتب سردًا بلا حدث، فإننا لا نعبّر عن عجز بل نقرّ ضمنيًا بأن الحياة في جوهرها ليست سوى تراكم لا أحداث فيه، مجرد عبور متكرر في المكان، نظرات إلى الخارج، نسيان مستمر، صمت يتخلله سؤال، إنّ السرد الذي يقبل بـ"اللاحدث" لا يستسلم، إنما يحتضن هذه الكثافة الخفية للعدم، هكذا يصبح "اللاحدث" في الرواية أو القصة لحظة اكتمال ناقصة، مرآة تعكس هشاشة وجودنا المعاصر، حيث الحدث الحقيقي هو إدراكنا لغيابه.
الآن وفي عالم يُقدّس الحركة والإنجاز والتوتر الدرامي، تأتي الرواية الصامتة، المتأملة، التي تسير ببطء شديد في زقاقٍ لا يؤدي إلى شيء، لتقول لنا شيئًا أعظم، تقول أن السرد لا يعني أن يحدث شيء بل أن نعي ما يحدث حين لا يحدث شيء، فليس من الضروري أن تشبه كل رواية زلزالًا، بعض الروايات تشبه الشمعة، تضيء بهدوء حتى تذوب، وربما نحن اليوم في زمن الاختناق أحوج ما نكون إلى هذا النور البسيط، إلى رواية لا تقول كل شيء إنما تُشعرنا بكل شيء، وهكذا يصبح "اللاحدث" حدثًا جماليًا عند الكُتّاب الذين يثقون بصمتهم.