مساحة إعلانية
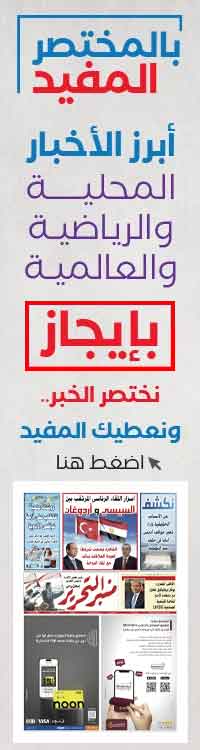


رأس كل شيء : أعلاه ، وتشير المعاجم العربية إلى أنه سُمِّي رأسًا لعلوُّه وارتفاعه، وهذا هو حال رأس الإنسان ففيها العقل واللسان والأذنان والعينان..
ولذلك نرى ضروريًا أن نتتبع السياقات القرآنية المختلفة التي ورد فيها هذا اللفظ مقرونًا بحركة، أو ثابتًا لنستنبط من هذه الصور التي ورد بها هذا اللفظ ما يمكن استنباطه من دلالات تربوية/نفسية إيمانًا منا بأن الإعجاز التربوي في القرآن الكريم يمكن التماسه في كل حرف وكل كلمة، بل وفي حركة الحرف نفسه على نحو ما أوضحناه في مقالات سابقة.
وتدل الدراسة الاستقصائية للفظ (الرأس) في القرآن الكريم على أنه ورد في ثمانية عشر موضعًا. منها ستة عشر موضعا أضيف اللفظ للإنسان، وموضعان فقط لغير الإنسان وهما قوله تعالى {يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بَقِيَ من الرِّبا...} [البقرة/279] حيث أُضيفت كلمة رؤوس إلى الأموال، وقوله تعالى: في وصف شجرة الزَّقُوم: {طلعها كأنَّهُ رُؤوس الشياطين} [الصافات/65]
فإذا تأملنا المواضع الستة عشر الخاصة برأس الإنسان ، أمكننا ملاحظة أن لفظ الرأس ورد مفردًا في سبعة مواضع ومجموعًا في تسعة مواضع.
ولم يرد بصيغة المثنى قط. وهذا أول ملمح إعجازي، إذ يستحيل أن يكون للإنسان رأسان.
وقد قدَّمنا أن الرأس تضمن العقل واللسان وحواسّ الرؤية والسمع والشم والذوق.
والملمح الإعجازي الثاني أن هذه المواضع جميعًا لم يرد فيها اللفظ نكرة، إذ كيف يكون الرأس محل اجتماع كل تلك الحواس مع العقل واللسان ويعبَّر عنه بصيغة التنكير التي تستدعي –نفسيًّا- لدى السامع أو القارئ معاني الحطة والدناءة والخسة والتجاهل في غالب دلالاتها؟ فالأليق أن يتلاشى الأسلوب القرآني الكريم صيغتي التثنية (لاستحالتها) والتنكير (لمنافاتها لمعاني الاحترام والتقدير والإكبار التي تلائم لفظ الرأس المرتبط –بأصل وضعه- بالعلو والارتفاع.
نكس الرأس :
وردت حركة (نكس الرأس) في موضعين أولهما جاء وصفًا لقوم سيدنا إبراهيم عليه السلام حين صُدموا برؤية أصنامهم محطَّمة، يقول تعالى. {فَرَجَعوا إلى أَنْفُسِهم فقالوا إنَّكُم أَنْتُم الظَّالمون، ثُمَّ نُكِسُوا على رُؤوسِهِم: لَقَد عَلِمتَ ما هَؤلاءِ يَنطِقُون} [الأنبياء/64-65].
والموضع الثاني في تصوير المجرمين يوم القيامة، يقول تعالى: [وَلَوْ تَرَى إِذْ المجرِمُونَ نَاكِسُوا رؤُوسهم عِنْدَ رَبِّهم: رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُون} [السجدة/12].
ففي الموضع الأول نرى السياق يكشف لنا حوارًا عنيفًا دار بين إبراهيم عليه السلام وقومه، حين رأوا أصنامهم محطمة، فأصابتهم الدهشة من هول المفاجأة، وصدمة المنظر المروِّع: آلهة تحولت إلى حطام حجارة والفأس المستخدم في التحطيم معلَّق في رقبة كبير تلك الآلهة!! فقالوا جزعين صارخين: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. ولما توجهت التهمة إلى إبراهيم عليه السلام لكثرة ما كان يسفِّه عبادتهم لتك الأحجار التي لا تضر ولا تنفع، استدعوه، وسألوه: أأنت فعلتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأشار عليه السلام إلى كبيرهم وعلى كتفه الفأس ساخرًا من عقولهم قائلا: {بل فعله كبيرهم هذا!! فاسألوهم إن كانوا ينطقون}!!.
الدلالات التربوية/ النفسية:
هذا الحوار بين إبراهيم عليه السلام وقومه نرى تنكيس الرؤوس فيه حافلاً بعدد من الدلالات تربويا ونفسيا منها:
1-أن حركة تنكيس الرؤوس جاءت تتويجًا لعدد من العمليات (النفسية/ العقلية/ الحركية تمثلت في:
أ-السؤال : الذي بدأت به هذه العمليات وجهه إبراهيم إلى أبيه وقومه مشيرًا إلى الأصنام {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟].
ب-الإجابة : سابقة التجهيز التي تعكس خلو رؤوسهم من أي تفكير أو تدبر {وَجَدْنَا آباءَنَا لَهَا عَابِدِين}.
ج- تسفيه الإجابة الجوفاء : وبخاصة إذا كانت الإجابة تحمل اعترافا صريحًا بعدم استعمال العقل أو الحواس استعمالا إيجابيا يحقق الاقتناع بالفكرة {لقد كُنْتُم أَنْتُم وآباؤُكُم في ضَلالٍ مُبين}.
د-مواجهة التسفيه بالتشكيك في الخصم : {أَجِئْتَنَا بالحقِّ أَمْ أَنْتَ من اللاعِبين؟}.
هـ-التهديد بمنطق القوة حال تجاهل قوة المنطق : حين قال إبراهيم لقومه: إن الأحق بالعبادة هو الله تعالى وحده لأنه رب السموات والأرض الذي فطرهن. ورفض قومه إعمال عقولهم رافضين قوة منطقه، لم يعد بعد قوة المنطق إلا منطق القوة فجاءت ردة فعله ملائمة لبرود مشاعرهم وتبلد أحاسيسهم {تالله لأكيدنَّ أَصنَامَكُم بعد أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرين} هكذا جاء تهديده إياهم علنيًا صريحًا لا مواربة فيه. وسرعان ما نفَّذه بالعقل {فَجَعَلَهُم جُذَاذًا إلاَّ كَبيرًا لَهُم لَعَلَّهُم إليهِ يَرْجِعون].
و-دهشة الصدمة :
حين رأى القوم أصنامهم محطَّمةً تساءلوا: {مَنْ فََعَلَ هَذا بِآلِهتِنَا}؟ وجاء توصيفه واتهامه بالظلم سريعًا لا يكاد ينفصل عن السؤال عمن يكون؟ {إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمين}.
ز-أهل الفتنة جاهزون في كل زمان ومكان
وفي غمرات التساؤل عمّن يكون ذلك الذي حطَّم الآلهة/ الحجارة. يبرز فريق معروف بين الناس بانتهازيته فيتقرب من رؤوس الظلم واشيًا محرِّضًا {.. سَمِعْنَا فَتىً يَذْكُرُهُم يُقالُ لَهُ إِبْرَاهِيم}.
ثم حدث ما حدث من استدعاء إبراهيم وسؤال عما إذا كان هو الذي ارتكب هذه الجريمة. وتجيء إجابته الساخرة من تعطيلهم عقولهم فيشير إلى الصنم الأكبر غامزًا في أصل عقيدة الجهل قائلاً {بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُم هَذَا فَاسْأَلُوهُم إِنْ كَانُوا يَنْطِقون!!}.
فيشعر بعض القوم الذين قُدِّر لهم إعمال عقولهم.. بالتسرع باتهام هذا الرجل مع أن الفأس معلقة على الصنم الأكبر {فَرَجَعوا إلى أَنْفُسِهِم فَقَالوا: إِنَّكُم أَنْتُم الظَّالِمُون}.
2-إن حركة تنكيس الرأس جاءت تعبيرًا عن الصراع العنيف بين العقل إذا استثير، والتقليد والتبعية العمياء.. وقد تمثل هذا الصراع النفسي الشديد في تلك العمليات النفسية التي مرت بنها (الاعتراف باتباع الآباء- الاستفسار عن فاعل الجريمة- قبول حجته ببراءته واتهام الصنم الأكبر- التفكير فيما ادعاه من البراءة واتهام الصنم الأكبر- التفكير فيما إ1ا كان الصنم الأكبر يستطيع أن يفعل ذلك أو لا يستطيع- اكتشاف حقيقة أن أصنامهم لا تنطق ولا تنفع ولا تضر..) هنا كان لابد من الشعور بالخزي والمهانة وضحالة التفكير، والاعتراف بالهزيمة النفسية/ العقلية أمام حجج إبراهيم وتحدياته فجاء وصف حالتهم {ثُمَّ نُكِسُوا .....يَنْطِقُون}.
3-وبناء الفعل للمجهول {نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهُم} فيه ملمح تربوي دقيق، وهو أن الإنسان إذا ما عطَّل قدراته العقلية، وتجاهل إمكانات حواسّه التي أنعم الله بها عليه، صار هشًّّا ليِّنًا يمكن لأية فكرة من هنا أو هناك أن تلعب به، ويقوده صاحب أي راي إلى حيث يريد. ولو كان الفعل مبنيا للمعلوم "نَكَسوا" بفتح الكاف وكانوا هم الفاعلين (واو الجماعة) لاحتمل المعنى أنهم خجلوا من إبراهيم فنكسوا رؤوسهم اعترافًا بجهلهم وعنادهم. أما بناء الفعل للمجهول فقد أوحى بمبدأ تربوي غاية في الأهمية، وهو أن الإنسان المقلِّد مسلوب الإرادة، قابل للاستهزاء، غير مؤهل للإبداع أو الترقي والله أعلم