مساحة إعلانية
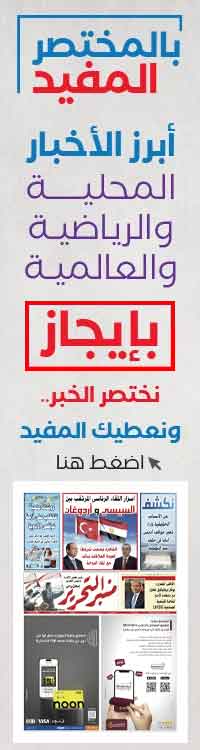


تعد صلاة القلق من أقوى الروايات و هي الفائزة بجائزة البوكر لهذا العام لكاتبها محمد سمير ندا ذلك الأديب الذي تربى وترعرع في بيت ثقافة و أدب فوالده الصحفي و الاعلامي سمير ندا عمل في مصر و العراق و ليبيا كمسؤول لبيوت الثقافة .
نشرت الرواية في تونس عام 2024 عن دار ماسكيلياني للنشر و التوزيع و حازت على الجائزة العالمية للرواية العربية ( البوكر ) لهذا العام .
و لنبدأ بقراءة الغلاف
1-الغلاف
الألوان والتكوين: الغلاف غالبًا يحاكي الطبيعة الصعيدية والسماء الداكنة بعد الانفجار – ألوان قاتمة (رمادي، كحلي، بني)، تتناغم مع الجو العجائبي والخوف من الحرب والوباء.
الصور والتراكيب والإضاءة: يُفترض وجود عنصر رمزي مثل عمامة أو وجه شيخ، أو أثر انفجار، مكتنف بإضاءة خافتة تعكس توهج القلق والخوف معًا. الكثافة البصرية تعمل على تأليب شعور التوتر والإبهام.
"صلاة القلق":
تحليل دقيق: تلاعب لغوي ذكي، حيث يُضفي على القلق صفة صلاة جماعية تُمارَس طقسيًا.
هي استعارة تربط بين الخوف الدائم كطقس شعائري من جهة وبين العبادة من جهة أخرى، ما يجعل القلق ليس مجرد شعور بل فعل جماعي وانشغال وجودي.
الفكرة المحورية: كيف يتحول القلق إلى فعل اجتماعي يجمع الناس، يسيّرهم، ويصبح تقليدًا مكتسبًا.
الثيمات الفرعية: تزييف الواقع، دور السلطة والإعلام (عبر "صوت الحرب"، خليل الخوجة)، الخلط بين الأسطورة والواقع، الضغط الاجتماعي، وخطاب المقاومة الداخلية.
التصاعد: يبدأ الانفجار الغامض ويليه انتشار الوباء؛ تتداخل ذاكرة النكسة/حرب 1967 بالنزيف النفسي.
ذروة متقطعة: تتوزع ذرى على شخصيات متعددة، ولكل فصل ذروة خاصة تمثل تحولًا داخليًا.
النهاية: كما وصفت المصادر، "خرق لنسق سابق" بإيراد وثائق تاريخية فعلية ، مما يدفع النص نحو مراجعة نقديّة للتاريخ الجمعي.
السرد متعدد الأصوات: ثماني شخصيات تروي من زوايا مختلفة، يخلطون الخيال بالواقع بأسلوب فسيفسائي .
الحوار: مدمَج ضمن السرد الشفهي أو المباشر، لا كتصعيد درامي منفصل وإنما كجزء من خطابات الشخصية وخلفيتها الثقافية.
جمالياتها: لغة شاعرية وعجائبية، لكنها محتشدة ومحكّة، وفقًا للنقاد .
التراكيب والبلاغة: مشبعة بالاستعارات والتشابيه (القلق ككائن حي، الصلاة، الحقل الألغامي... إلخ).
المكان: "نجع المناسي" في صعيد مصر، معزول ومحاط بالألغام – يرمز للانعزال الفكري والاجتماعي.
الزمان: سبعينيّات القرن العشرين (بعد نكسة 1967 وحتى 1977) . الزمان ليس مجرد حيز، بل عامل زمني للتشويش بين التاريخ الرسمي والذاكرة الجماعية.
ثمان شخصيات مركزية، وتُخلص إليهن كما يلي:
الشخصية .. التحليل والنمو الدرامي
خليل الخوجة : ممثل السلطة المهيمن، يحكم عبر الوهم والخوف – تطوره يمثّل خلافة الزيف على تبريراته.
نوح النحال : صوت الحكمة والمقاومة الداخلية. يمثل الفعل الواعي ضد الوهم.
محروس الدباغ : بالغ التفكير والعزلة الذهنية، يشكل رؤية نقدية تقابل السلطة.
وداد القابلة: ترتبط بحبل الحياة والنفوس – تعكس تناقض السلطة البيولوجية والاجتماعية.
عاكف الكلاف: بين الحقيقة والخيال، يعكس التردّد الإنساني في الرؤية.
محجوب النجار: مشروع هروب رمزي عبر نفق – تمثل الرجاء في الخروج من القلق.
شواهي الراقصة :امرأة تنجو وسط الاضطهاد – تُجسّد المقاومة العرضية الأنثوية.
الشيخ جعفر / أيّوب المنسيّ رمز ديني بحقه أو بعملة هذا القدر، يتبلور في النهاية كوعاء للنهاية المالية والروحية .
العقدة : الخلط بين الأسطورة (قصة الألغام المستمرة، الحرب الحقيقية) والوباء، ما يجعل القلق عقدة مشتركة اجتماعيًا.
الحل: لا حل نهائي واضح، فالرواية تترك النهاية مفتوحة وتخضع للتاريخ الحقيقي – إذ يستدعى للتدخل المباشر بسرد وثائقي .
نقاط القوة:
بنية سردية فسيفسائية متعددة الأصوات.
لغة قوية ودقيقة محكمة .
استثمار رمزي عالٍ لاختزال الكثير من القضايا عبر قلق صغير (النجع).
نقاط الضعف:
كثرة الأصوات قد تربك القارئ وتضعف الاتصال الشخصي ببعض الشخوص.
الرمز المفرط (صلاة، ألغام، أمثلة قرآنية...) قد تحتاج توضيحًا إضافيًا للقارئ غير المطلع على السياق التاريخي/الديني.
"لقد قدّمت عملاً سردياً مستكشفاً بجرأة ثيمات الصدمة والجنس والسلطة والهامش، بأسلوب متماسك وسرد يوازن بين الفانتازيا والتاريخ. مع أن نسيجك الفسيفسائي عالٍ، لكن توصية: حافظ على إحساس القارئ بالربط الشخصي بالشخصيات حتى في تعدد الأصوات."
"هل فكّرت بإدراج 'مفتاح سردي' في بداية أو نهايات العمل ليساعد القارئ على التفاعل مع الثيمة المركبة؟ أو هل يمكن إعادة توزيع الأصوات في نسخة لاحقة لضمان ثبات تواصل درامي عاطفي أوسع؟
خلاصة:
صلاة القلق رواية متميزة في الشكل والمضمون، تنجح في خلق عالم مُركّب مفعم بالخوف، وتفتح الأسئلة حول السلطة والتاريخ، لكنها تحتاج ميزاناً بين الرمزية الكثيفة والارتباط النفسي المباشر بالشخوص.
