مساحة إعلانية
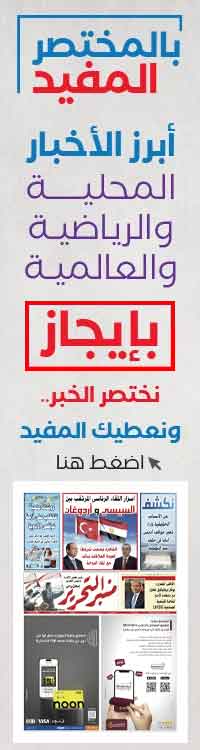


قراءة : عبدالنبي عبادي/ نقادة

بتحليل شعر حُسني الإتلاتي نكتشفُ أن شعره يمتلكُ حُزنا "كُحزن الرّومانتيكيين"، وهو توصيف ذكره مرّة النّاقد الرّاحل عبدالجوّاد خفاجي وأتّفقُ معه في ذلك، فالإتلاتي تحكمه كثيرا الرغبة في التعبير عن الذاتية والوجدانية والهروب من الواقع الأليم -بعد فضحهِ- إلى عالم الخيال، لكنّني أذكركم بضرورة التفريق بين الرومانسية كحس إنساني وكمدرسة أدبيّة، فهي فِطرة اللّه التي فطر عليها قلوب البشر حيثُ الميل إلى المؤانسة والجمال والطّبيعة، لكنّ من حيثُ كونها تيارا أدبيا، فهي نتاج عوامل من بينها الثّورة على الكلاسيكيّة (شكلا ومضمونا) وكذلك التأثّر بالرومانتيكية الغربيّة. وفي هذه القراءة التحليليّة للمجموعة الشعريّة يؤرّقه الحنين ( الصادرة عن ديوان العرب للنشر والتوزيع ) سأتعرّضُ بالعرض والتّحليل للنص الموازي ودلالة العناوين والحُب والعشق ودلالة الأسماء وسطوة الأنا.
أولا : النصُّ الموازي في "يؤرّقه الحنين":
لا يُمكننا أن نلتفت إلى النصّ الشّعري مُتجاهلين مُحيط النصّ الشّعري أو ما يُسمّى "عتبات النصّ" الشّعري أو النصّ الموازي، فالصّولي مثلا ركّز في كتابه "أدب الكاتب" على العنونة وفضاء الكتابة وأدوات التحبير والترقيش وكيفيّة التّصدير والتّقديم والتّختيم وبحسب جيرار جينيت فإن النصّ الموازي أو ما أُسمي النّصُ المُتعالي يشمل العنوان والعنوان الفرعي والعناوين الدّاخليّة والمُقدّمات والمُلحقات والتنبيهات والتمهيد والهوامش وعبارات الإهداء والشّكر وغيرها وطالما قال جيرار جينيت : "احذروا العتبات" وذلك لأن تلك العتبات هي باب الولوج إلى النصّ وهي تفتح مغاليق النّصوص وتُساعد في رفدها بما يُزوّد طاقتها الشّعريّة ويشحذ قُدرتها على الوصول إلى القاريء عن طريق التّقاطعات التي تُحدثها هذه العتبات بين الوعي الشّعري للشّاعر وبين وعيه بعملية الكِتابة النصيّة في المُجمل.
وعلى هذا فإن للنص الموازي وظائف دلالية وجمالية، فهو يساعد المتلقي على فهم خصوصية العمل الأدبي، ويشير د. حمداوي إلى أن للنص الموازي وظيفتين : وظيفة جمالية تتمثل في تزيين الكتاب وتنميقه، ووظيفة تداولية تكمن في استقطاب القارئ واستغوائه، كما أنه يقسم النص الموازي إلى قسمين : الأول النص الموازي الداخلي، ويقصد به تلك الملحقات النصية والعتبات المتصلة بالنص مباشرة ويشكل كل ماورد محيطاً بالكتاب، والثاني النص الموازي الخارجي، ويقصد به كل نص سوى النوع الأول، ويكون بينه وبين الكتاب بعد فضائي وأحياناً زماني، ويحمل صبغة إعلامية مثل الاستجوابات والمذكرات والشهادات والإعلانات..
1- شعرية العنوان :
العنوان شكلاً ومحتوىً هو نص موازٍ لما هو داخل الكتاب. إنه جزء غير بريء من تاريخ الكلمات. ولأنه كذلك يمكننا القبول بقول من قالوا بأنه عتبة واقفة بين يدي النص، لا يمكن تناسي وجوده وإن تظاهرنا أننا تخطيناه. إنه علامة ألسنية بامتياز تحدد أفق توقعات المتلقين منها. إنه نص باعتباره يميز جنس المادة المقروءة، وينشئ مع المتلقي تعاقداً غير مكتوب، على قبول ما به، على ما هو
الكتاب.وقد كان يُنظر إلى العنوان باعتباره مجرد ضوضاء لا بد منها، أو ملفوظ يبغم ولا يتكلم، ثم لا يضيف إلى أدوات التحليل النصي شيئاً. لقد مضى ذلك الزمن وأصبح الدرس الأدبي الحديث يولي العنوان ما يستحقه من الاهتمام، وغدا الدارسون اليوم يحاولون الغوص على دلالات مضمونه الإجمالي، لا في الأدب فحسب بل في باقي الأجناس الفنية ـ كالسينما والموسيقى ـ نظرا لوظائفه المرجعية واللغوية والتأثيرية والأيقونية وميزوه بدراسات معمقة بشرت بعلم جديد ذي استقلالية تامة، ألا وهو علم العنوان الذي ساهم في صياغته وتأسيسه باحثون غربيون معاصرون منهم جيرار جينيت ، وهنري متران، لوسيان كولدمان، شارل كريفل، روجر روفر، ليو هويك ومن العرب جمال بو طيب:(العنوان في الرواية المغربية)، عبد الفتاح الحجمري:(عتبات النص: البنية والدلالة)، جميل حمداوي( السيموطيقا والعنونة)،(مقارنة النص الموازي في روايات بنسالم)،
يقول ليو هويك في تعريفه للعنوان بأنه (مجموعة من الدلائل اللسانيّة يُمكنها أن تُثبت في بداية النصّ من أجل تعيينه والإشارة إلى مضمونه الإجمالي ومن أجل جذب الجمهور المقصود.)
وفي عنوان ديوان "يؤرّقه الحنين" نجد أن الجُملة الفعليّة جاءت في تركيبها البسيط من الفعل "يؤرّق" والمفعول به ضمير مُستتر تقديره هو و "الحنين" فاعلٌ وهو ما يُفيدُ استمرار هذا الأرق وتجدده بتجدّد الحنين. ولو تأمّلت لفظة "يؤرّق" فستُحيلك إلى وقت "الليل" بينما "الحنين" يُحيلُك إلى "الماضي" في شبكة دلالية على هذا النّحو :
يؤرّق = اللّيل
الحنين = الماضي
وكأن العنوان هو "يؤرّقُ الشّاعر الحنين في الليل إلى الماضي" أو "يؤرّق الشاعر في الليل الحنين إلى الماضي" أو غير ذلك من استخدامات للتقديم والتأخير وكلّها لن تخرج عن دائرة اشتباك الأرق مع الليل والحنين مع الماضي وكأنها مُعادلة رياضيّة مؤدّاها ( الأرق× الليل = الحنين إلى الماضي) والعكس.
وقد اختار الشّاعر هذه الدوال "يؤرّقه الحنين" بوعي أو بلا وعي ليربط ثنائيّة الحنين والماضي والأرق والليل بموضوع ديوانه الأبرز ولو رددت الفعل يؤرّق إلى مادتّه الأساسية، ستكون "أرِقَ" في مُقابل "حنّ" ولها دلالة الانسجام حيثُ ترد ثلاثة حروف مُقابل حرف مع حرف مُضعّف أي ثلاثة حروفٍ أخرى وهذا التّعادل العددي في الحروف مُثير من وجهة نظري لأنه ضاعف من حدة القلق وأزاحه عن دلالته المؤقتة إلى دلالة مُستمرّة مُتجددة.
2- العنوان :
أعادت الشعرية الحديثة الاعتبار للإهداء بعد أن اعتقد البعض أنه إشارة لغوية لا تساهم في تفسير النص وتحليله، فأرفق كثير من الشعراء نصوصهم الإبداعية بذكر الإهداء باعتباره نصاً موازياً يقدم النص ويعلنه ويوجه المعنى(داغر، 1988 : 22) وأصبح من الضروري قبل الدخول إلى النص الوقوف عند الإهداء لما يحمله من دلالات معينة، وظاهرة الإهداء كما يري جيرار جينت قديمة تعود جذورها على الأقل إلى الإمبراطورية اليونانية وهو أيضاً تقليد عرفه الشعر العربي القديم والحديث، فكان الشعراء يهدون القصيدة إلى هذا الأمير أو ذاك طلباً للتكسب
أو مدحاً خالصاً. أما في الشعر الحديث والمعاصر فقد صار يحمل دلالات مغايرة.
فالإهداء بحد ذاته كتابة رقيقة متعددة الكيفية توجه إلى المهدى إليه الذي قد يكون فرداً معروفاً أو مجهولاً أو جماعة معروفة أو مجهولة، وقد يكون غيريا أو ذاتياً، ويكون بإهداء العمل وهو هنا فعل رمزي ذو طابع عام ويكون بإهداء النسخة وهو هنا فعل حميمي خاص، وهو في كل الأحوال عتبة نصية لا تنفصل دلالتها عن السياق العام لطبيعة النص الشعري وأبعاده الإيحائية والمرجعية، والفائدة الفنية لهذه الإهداءات أو النصوص المصاحبة تتمثل في محاولتها بلورة فكرة الشاعر وإشارته إلى محور آرائه ومنبع عواطفه وفي ذلك ما قد يساعد دارس الأدب وناقده ومؤرخه في قراءة النص والإهداء بشكل عام صيغة واحدة تتألف من العناصر الستة التالية : المُهدى، المُهدَى إليه، أسباب الإهداء، صيغة الإهداء، توقيع المُهدي، وزمن الإهداء. لقد جاء إهداء ديوان "يؤرّقهُ الحنين" بالصّيغة الآتية :
إهداء
إلى آمال مصطفى سيد شريكة الكفاح ورفيقة العمر وأم أولادي
حسني الإتلاتي
وهو إهداء مُباشر لزوجته التي أشار إليها بثلاثة دوال، فهي "الشريكة" في الكفاح و "الرفيقة" العمر و "الأم" للأولاد. ويؤدّي الإهداء – إلى جانب وظيفته الشعرية كنصّ موازي- وظيفة اجتماعية عن طريق تقريب الشّعر للآخرين وجعْله مُكافأة لهم أو جعلهم مُحرّضين عليه مما يُكسِب الشّاعر مساحة أكبر لدى المُتلقّي الذي يجد نفسه أيضا "نصا" موازيا للكتاب الشّعري وعتبة فوقية خارجيّة للنصّ الشّعري!
1- التّصديــر:
قدْ تكون كتابة "مُفتتح" أو "تصدير" أو "إشارة" في بداية المجموعات الشعريّة "موضــة" لا أكثر في كثيرٍ من المجموعات الشعريّة وما هي إلا انعكاس لشعور ما – لدى الشعراء- مؤداه أن الرّسالة لن تصل على الوجه المطلوب أو أن الشعر سيبدو عاجزا – وحده - عن العبور بفكرة ما للمُتلقي ومن ثمّ فالشّاعر بحاجة إلى مُتعاليات نصيّة موغلة في التكلّف، يبدو لي الإصرار على تصدير الشعر بغيرهِ كأننا نستعينُ بنصّ فَوقيّ تاريخانيّ لكشفِ حِيلِ نص جديد مُحتَمَل أو كأن الشّعر يطلُبُ في غيره الوسيلة. تلك هي "الثقافة" التي تُطل علينا من شُرفة الكتاب ثم تعودُ للتخفّي حينا وتظهر حينا في النّصوص، لكنّها دائما موجودة. لكن وضع تلك الإشارات في بداية المجموعات الشعرية قد يكون من ناحية أُخرى كشفًا مُبكرا عن السّحر الذي يُفترض أن نُمارسه حتّى النّهاية دونما الكشف عنه ، فالسّاحر لا يكشفُ عن سحره كما في قول محمّد علي شمس الدين في قصيدةِ له بدأها ببيت المتنبي المشهور : أنا السابق الهادي إلى ما أقوله إذا القول قبل القائلين مقولُ
يقول شمس الدين :
(1)
لو بُحتُ بسرّي
من يمنحني
سرّ الغامض
والمكنون؟
من يحجبُني
ثانيةَ
كي
يسأل عني الناسُ
وأملا حيرتهم بكلامي؟
وأظنُّ أن الشعراء سيعودون اليوم لكتابة مُقدّمات نثريّة لمجموعاتهم الشعريّة وهذا أمرٌ يحتاجُ فضل دراسةٍ وتفصيلٍ لا طاقَةَ لَنَا بهِ الآن غير أني أستطيعُ أن أوجِزَ الأسبابَ التي قد تجعلُ شاعرا يكتُبُ تصديرا لشعره أو يختارُ تصديراً ما دون غيره من خلال كشف النسق المضمر في تصدير حسني الإتلاتي لمجموعته الشعرية "يؤرّقه الحنين" والذي يُعطينا صورة كُليّة عن الدّيوان قائلا :
تصدير
كلماتي ليست سوى نزيف
كل كتابة لا تقطر دما لا يعوّل عليها
المؤلّف
يبدو "التصوّف" نسقا مُضمرا في وظيفة الكِتابة، فمن ناحية هي أداة للتغيير في حالة أن نعوّل عليها وفي حال كونها غير صادقة وغير مُعبّرة عن شاعرها ولا تجري منه مجرى الدّم فلا يُعوّل عليها. تجيء دلالة التركيب "كلّ كتابة لا تقطر دما لا يعوّل عليها" صوفية متبنيه علاقة الحرف والكلمة بآفاق المعرفة الصوفيّة وهو تضمين لفكرة ابن عربي في رسالة ما لا يعوّل عليه ومنها : (كل شوق يسكن باللقاء لا يعوَّل عليه.المكان إذا لم يؤنث لا يعوَّل عليه) ثم نلاحظ أن التوقيع تغيّر من "حسني الإتلاتي" الوارد في الإهداء إلى "المؤلّف" الوارد في التّصديـر وذلك إِشارة إلى وظيفة الكاتب هُنا ودوره الذي يلعبه في فضاء النصّ وفي الواقع، فالنزيف المقصود هُنا هو الصّدق والبوح اللامحدود ومواجهة الهزائم والانهزامات بشكل فيه كثير من الإيمان بجدوى الكتابة وبدورها . ، ويكشفُ هذا التّصديـر مُنطلقات القصائد ومُثيرات الفكر التي حركت الشاعر للبوح بما باح به. كما تُشيرُ إلى أن الشاعر ينهل من مصادر شتّى منها النّبع الصّوفي. لقد صار السّردُ والنحتُ والرّسم والموسيقى والمسرح والنّقد والسينما هم ألوان الطيف في القصيدة المُعاصرة وبالتالي فالشُّعراء يُفيدون من هذه الفنون في مُتون نصوصهم الشعريّة اليوم. ولا غرابة في أن نجدَ مجموعةً شعريّةً مُصدّرة بمقطعٍ سردي من رواية أو صورة فنيّة لمنحوتة ما أو شخص ما كما أن استخدام تقنيات المسرحة واردٌ جدا في الكتابة الشعريّة ، كيف لا والمسرحُ أبو الفنون والمسرحيّون هُمُ الشّعراء!
وفكرة تداخلُ الفنون قديمة في تطبيقها وليست وليدة العصر أو رديفَ الحداثة، لكننا قد نجدها مُضفّرة ومُدمجة في ثنايا النّصوص أو أشكالها وليس في صورة عتبات أو مُتعاليات. أنظر مثلا إلى الجلياني في "ديوان التدبيج" الذي قام بتحقيقه الناقد الدكتور كمال أبو ديب بالاشتراك مع الدكتورة دلال بخش، الأستاذة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة. ويضم الكتاب دراسة مُطوّلة للشّعر المُجسّد بصريا concrete poetry. وقد اعتبر موكاروفسكي Mukarovsky هذا التداخل "أماميةَ" الدال في الشعر Foregrounding قبل أن يُعيد ياكوبسون صياغتها فتصبح وظيفة بنيوية للغة. كما أن التداخل بين الشعري والسردي يطرح إشكالية قديمة جديدة، وهي قضية الأنواع أو الأجناس الأدبية، حيث يظل السؤال ماهي حدود كل جنس أدبي؟ وهل يمكن الحديث عن حدود صارمة بين الأنواع؟ يرى تودوروف بأن الشعرية برمتها تتجاوز الأجناس الأدبية، ولا تراعي سوى النسق الذي يشكل خطاباتها فهو يقول: "إن الاهتمام بالأجناس الأدبية قد يبدو في أيامنا هذه تزجية للوقت لا نفع فيه إن لم يكن مغلوطا تاريخيا". لقد زالت الفروقات إلى حد ما بين الشعر كما أسسه الأقدمون، والنثر لدرجة أنه صار لا يعبأ بالأجناس وهذا ما يعرف بمبدأ طمس الأنواع في النظرية الأدبية الحديثة، مقابل مبدأ نقاء النوع في النظرية الأدبية الكلاسيكية.
1 –دلالات العناوين:
جاء الديوان في ستة وثلاثين قصيدة بين القصيرة ومتوسّطة الطّول وأقلّها الطويلة. وقد رصدتُ سمةً غالبة في عناوين القصائد - وهي كما أسميناها من قبلُ "النصّوص الموازية" – وهي سمة استخدام اسم نكرة عنوانا للقصيدة، حيث نجد 28 عنوانا باستخدام اسم نكرة بما يُعادل 70 بالمائة من العناوين هي ( صلاة، ثقوب، شجر، صبر، طفولة، رسول، عتاب، ميثاق، انتباه، غيوم، عطر، غرباء، كبرياء، سلام، تنورة، لعبة، فناء، طمع، زهد، ملائكيّة، جحود، رجاء، انتماء، مجذوب، بيت، خضوع، بعث) وقصيدة واحدة عنوانها (لو) الشرطية: تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، أي امتناع شيء لامتناع غيره، وقصيدة حملت اسم معرفة (المغنّي) وقصيدتين بأسلوب النّداء هُما (يا مجرمون) و (يا يثرب النّور) وثلاث قصائد بتركيب إضافة نكرة إلى نكرة هي (مقدمة طللية، وتجليات السين، و نزيف داخلي) وإضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص وبالتالي تحدد دلالة العنوان لدى المتلقي وجاءت قصيدة واحدة احتوى عنوانها على نكرة مضافة إلى معرفة هي (تجليّات السين) فالاسم هنا معرّف بالإضافة. ودعونا نسأل سؤالا وهو : لماذا لم يستخدم الشّاعر جملة فعلية واحدة أو فعلا واحدا عنوانا رُغم أن العنوان الذي ضم هذه القصائد هو جملة فعلية (يؤرّقه الحنين؟ أو ما دلالة استخدام اسم نكرة في ثُلثي عناوين الديوان؟ إن التنكير هو الأصل في الأسماء، والتعريف فرع فيها، وهذا هو قول جمهور النحاة، وعللوا ذلك بعلل منها
مذهب سيبويه حيث قال: "وأعلم أن النكرة أخفُّ عليهم من المعرفة، وهي أشدُّ تمكُّنا؛ لأنّ النكرة أولّ، ثم يَدْخلُ عليها ما تُعَرَّف به. فمن ثَمّ أكثرُ الكلام ينصرف في النكرة" وهو ما يؤكّد رغبة الشّاعر في التخفّف من كثير من أعباء اللّغة والوصول بها لأبسط تشكيلاتها رغبة في البوح وفي طرح موقفه الذّاتي من الحياة التي بدا وكأنّه في موقف صراع معها مُعلنا عنه فيما أسماه "مقدّمة طلليّة" للديوان وهي أولى قصائد الدّيوان وقد سلك مسلك العرب القدامى في بدء القصيدة بالبُكاء على الأطلال لأن الطلل هُنا مُعادل للحنين الذي يُكابده الشّاعر، فهو بناء غير مُكتمل، أو بقايا بناء له في كثيرٌ من الذكريات والرغبات التي فاتت وما زال يأكله حنينُه إليها، لكن هذه المُقدّمة الطلليّة تجيء كــ (مانيفستو) أو بيان تأسيسي يستهدي به القاريء، يقول الشّاعر :
طفلا أحاول خدش الحزن عن زمني
لي غربتان ولي روحان في بدني
من ألف أمنية ما نلت أوهنها
مالي وهنت وذي الآمال لم تهن
كطائرٍ هاربٍ لا عش يجمعه
أفر من وطني يمشي معي وطني
من بحر "البسيط" (مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن) صاغ الشّاعر حسني الإتلاتي بيانه الشّعري الأول منبئا عن موقفه من الحياة ومن الوطن، لا يرفُضُ الوطن ولكنّه يفرّ من خطايا هذا الوطن بينما الوطن معه، وطنه المُتخيّل (أفرّ من وطني، يمشي معي وطني) وهذا انعتاق من أسر الجُغرافيا إلى رحابة الشّعر، فالشّاعر هُنا يصطحب وطنه المخصوص الذي يصنعه على عينه في مواجهة موجات الحُزن التي تندفع إلى شاطئ الحياة بين حينٍ وآخر. وقد اختار الشّاعر "البسيط" بحرا لهذا البيان الشّعري لأنّه البحر الذي ألفته أسماع المتلقين. إن البحر البسيط يقرب من البحر الطويل ولكنه لا يتسع مثله لاستيعاب المعاني ولا يلين لينه للتصرف بالتراكيب والألفاظ مع تساوي أجزاء البحرين و هو من وجه آخر يفوقه رقة وجزالة ولهذا قل في شعر أبناء الجاهلية و كثر في شعر المولدين. وهُنا يجيء الشّاعر طائرا هاربا من عُشّه\وطنه فارّا بعشّه\وطنه المُتخيّل.
ثانيا: دلالات الأسماء:
في قصيدة "طعنات مرحلة"، يقول الشّاعر :
مسيحٌ جئتُ أرفُل في أساي
أضمد جرحكم فرحا وشاشا
حسين كربلاء بكل قلبي
أذود الموت .. سيف القلب باشا
لا شك أن الموازنة التي ساقها الشّاعر بين "المسيح" و "الحسين" غرضها محاولة تحسّس موضع الشّاعر من الحياة بين هاتين السّرديتين، سرديّة المسيح عليه السّلام وسرديّة الحُسين بن عليّ عليه السّلام فجاءت الأسماء هنا مكنزا لظلال تاريخيّة وفكريّة مُتحررة من سطوة الدّين الواحد إخلاصا للفِكرة الواحدة، فِكرة الخلاص من تناقضات هذه الحياة بروح المُخلّص الذي ينتظرُه النّاس حالا لمُشكلاتهم ومنتصرا على أوجاعهم، والمُخلّص هُنا- رُغم آلامه- هو الشّاعر نفسه، لأن صورة الدّم المُتضمنّة في الأبيات السّابقة تُحيلُنا مرة أخرى إلى تصديــر الكتاب الذي قال : (كلُّ كتابة لا تقطُرُ دما لا يُعوّل عليها).
ومن لطائف القول أن كلمة (مسيح) وكلمة (حُسين) اشتركتا في في حروف (السين) و (الياء) و (الحاء)، فالسّين من الحروف المهموسة ومخرجها من طرف اللّسان، والياء من حروف الجوف كما يقول الأزهري، وكان الخليل ابن أحمد الفراهيدي يسمي أحرف الجوف ومنها الياء الحروف الضعيفة الهوائية؛ وسميت تلك الحروف بحروف الجوفاء لأنه لا أصول لها ترجع إليها، إنما تخرج من هواء الجوف، فسميت مرة جوفًا، ومرة هوائية، وسميت بالحروف الضعيفة بسبب انتقالها من حال إلى حال عند التصرف باعتلال، أمّا (الحاء) حرف رخو هامسٌ مُنفتح (من فتح الشّفتين) وهو من الحروف الحلقيّة التي تخرج من الحلق وهو ما يعني أن كلمتي (حسين) و (مسيح) بهما طاقة صوتيّة مُشتركة وهي موزّعة في كليهما بين الجوف والحلق واللّسان وهو ما دلالته تعبير هذه الحروف عن مُشاعر مُتناقضة ومُتنافرة من ناحية، صادقة من ناحية أُخرى.
ثم يقول في قصيدة "أخضر" :
سننتظر النهارَ يعودُ عدلا ..
يوزّعُ قمحه بالرّاحتين
سننتظر النهار يعود يوما
شريف القلب أخضر كالحُسين
وهُنا لا بد أنك لاحظت معي اختلاف دلالة "الحسين" في النصّين، فرغم أن الاسم هو نفسه وهو يُشير إلى شخصية واحدة لكن السياق الشعري المعنوي الذي أتي فيه هذا الاسم حمل دلالتين مُتناقضتين تناقض حياة الشاعر. في المقطع الأول ورد الحُسين الذي رفل في أساه مُخلصا لرسالته وفكرته يذود عنها حتى الموت ولكن في المقطع الثّاني يجيء الحُسين أخضر وفيه إشارة إلى باب الحُسين الأخضر وإلى الحرير الأخضر الذي يُغطّي ضريح رأس الحُسين المُفترض، لكنّ دلالة الأخضر تنسحبُ أيضا إلى التجدد والنّماء والتوالد والظهور والنقاء وهو ما يطمح إليه الشّاعر لا سيما وأنه تحدّث قبلها عن النّهار الذي يوزّع القمح على الجائعين.
وفي قصيدة "تجليات السين" يقول:
كشفت كبلقيس زجاجا رائقا ..
روحي سكبتُ على البساط السندسي
أشتاقُ نورك بي لنورك حاجة ..
ما اشتاق سيف (صلاحَ) بيت المقدسِ
فمن ملكة سبأ إلى صلاح الدّين الأيوبي مُحرر بيت المقدس تشعّ دلالات مُتباينة بين الجمال والأناقة إلى القوّة والفتوّة والفتوحات وهو ما يثيرُ نزعات النّفس البشرية من توق إلى الجمال وافتتان بالقوّة لا سيما في نصرة الحق.
ويقول في قصيدة "طمع" :
ما كنتُ شمس الدّين في تبريزها
أو يوسفا أرقى لسجن عزيزها
أنا واحد شق الظلام طريقه
فمشى بوحلته على إبريزها
ولد قليل الحظ أهدر عمره
يرجو من الأيّام بعض خبيزها
تجدر الإشارة هُنا إلى أن شمس الدين التبريزي محمد بن ملك داد التبريزي (مواليد 1185 تبريز- 1248 خوي)، (582-645 هـ) عارف وشاعر متصوف، كتب جل شعره بالفارسية وأقله بالتركية والعربية، مسلم صوفي المشرب شافعي المذهب ، يُنسب إلى مدينة تبريز. يُعتبر المُعلم الروحي لجلال الدين الرومي (مولانا). كتب ديوان التبريزي (الديوان الكبير) الذي كتبه في مجال العِشق الإلهي ، قام برحلات إلى مدن عدة منها حلب وبغداد وقونية ودمشق. أخذ التصوف عن ركن الدين السجاسي، وتتلمذ عليه جلال الدين الرومي. اعتكف شمس التبريزي وجلال الدين الرومي أربعين يومًا في مدينة قونية لكتابة قواعد العشق الأربعون، ثم قام شمس التبريزي بالفرار إلى دمشق قبل أن يعود إلى قونية. ثم قُتل في قونية (وإن كان البعض يقول أنه قُتل في مدينة خوي وهو الأرجح) على يد جماعة من المناوئين له سنة 645 هـ، وقيل سنة 644 هـ. وله ضريح في مدينة خوي، ورُشح ضريحه ليكون من مواقع التراث العالمي لليونيسكو.
ما يعني أن اسم التبريزي ينفتح على دلالات صوفيّة واسعة المعاني يبغيها الشّاعر ولكنه عجز عن تحقيقها بسبب منغصّات كثيرة، فلا هو تفرّد بالمعرفة والكشف ولا هو اختصّ بالجمال كيوسف عليه السلام ولكن الظلام الذي أحاط به وشق طريقه إليه جعله ولدا قليل الحظ، يندب حظّه ويبكي أيّامه التي حالت بينه وبين مواجهة الملوك.
ثالثا : سطوة الأنا
بحسب نبيل عبدالفتّاح يمثّل الشعر أحد جواهر الوجوه والتجربة الإنسانية في تحولاتها ومساراتها الجماعية والفردية التي تعبر عنها الأنا الشاعرة المتفردة، في كثافة وتركيب وإيجاز، وتخييلات حاملة معها الذاكرات الفردية والجماعية والخبرات الاستثنائية، والألم والأسئلة والتباسات الوجود والوعى والرموز والأساطير والأوهام.
من هنا كانت الأنا الشاعرة تستصبر الشرط الإنساني، منظوراً إليه من ثقافات العالم وتحولاتها ورؤاها حول الإنسان والمصير، من هنا تعددت التجارب الشعرية وفضاءاتها المتعددة الأبعاد، على نحو شكلت معه تجربة الأنا الشعرية، عالمها الخاص ولغتها الخاصة، ورمزياتها لدى الشعراء العظام في كل ثقافة، ومرحلة تاريخية. وقد توزّعت صورة الأنا الشّاعرة عبر هذا الدّيوان بين المُناضل والعاشق المتصوّف والمُحب المُدلّه والمُهمّش المغلوب على أمره، وهو ما يعكس ثراء التجربة الإنسانية وانفتاحها على الحياة بكل ما فيها من كد ونكدٍ وألم وأمل.
فالشّاعر طفلٌ يستذكر طفولته وما كان من حُلم في قصيدة (طفولة) قائلا :
كنا وكان غموس الخبز في يدنا
ملح على ريقنا أحلى من العسلِ
في الحقل تجمعنا-أهلا- مواسمُنا
عند الحصاد نزقّ اليأس بالأملِ
حتّى يصل إلى قوله :
نم يا صغيري أبوك الآن في تعبٍ
وأنت يا طفلتي بعضا من القبلِ
تدور دورتها الأطفال قد كبروا
من يخبر الطفل أني الطفل لم أزلِ
فما بين طفولة مضت كمرحلة عمرية بكل ما فيها من حلم وحب وبين عمر يتقدّم وتتزايد معه مكائد الحياة وصفعاتها بينما يظلّ قلب الشّاعر وروحه طفلا يتوق إلى أن يدفع اليأس بالأمل وينظر للحياة بعين الفضول والاستكشاف والرّغبة في الانتصار، لكن هيهات هيهات فالحياةُ لا ضمير لها لتقيم معادلة عادلة أو تُعطي نتائج سليمة، يقول في قصيدته (سلام) :
لن تشعر الأيامُ وخز ضميرها
مرت كبارُ همومها كصغيرها
أيامُك الرعناء يهدأ طعنها
إن كنت أصغرَ فارقت بحقيرها
لكن لي نفسا سمت أشواقها
كنت الجدير ولم أفز بجديرها
لا تحزني يا وردةً بدمي غدا
نرتاح فوق سعادة وسريرها
يُعزّي الشّاعر نفسه ويصبّرها انتظارا لغد سعيد يأتي ويتظاهر بالفرح ويبتسم مراوغا الآخرين وربّما في محاولة لإغاظة الحياة، قائلا في قصيدة (زهد) :
سأبسمُ كي تظنوني سعيدا ..
وليس القلبُ صخرا أو حديدا
ولكني جُبلتُ على التسامي
فلا وعدا أخافُ ولا وعيدا
سأبسم ثم أبسم، ثم أبكي
طويلا حينما أخلو وحيدا
أي أن الأنا الشّاعرة تدور في دوائر مُتقاطعة أحيانا ومُتداخلة أحيانا أخرى أو منعزلة عن بعضها البعض، حيث لكل إنسان منا "أنا" تعبر عن خفاياه ومكنوناته، وتجلياته. حيث إنه يقصد بمفهوم " الأنا" المكنون من الشخصية الذي يتعامل مع العالم الخارجي ومطالبه العملية، وبتحديد أكثر، فإن الأنا هي التي تجعلنا ندرك ونفكّر. والشاعر يبدأ حديثه عن الأنا؛ لأنها أقرب شيء إليه، وهى تمثل الجانب الواعي من الشخصية الإنسانية، كما أنها تمثل حلقة الوصل بين ذات الفرد والعالم الخارجي حيث إن الشعر بصفة عامة يبرز من خلال شعر شعرائه بما فيه من أهواء وتأملات تكشف كينونة الشاعر وتفصح عن موقفه من الحياة الذي أعلنه الإتلاتي في بداية الدّيوان عندما ساق مقدمة طلليّة هي الأكثر إظهارا للأنا الشّاعرة حيث تقف الأنا الشّاعرة على بقايا الدّيار مستشعرة ألم وحزن الموقف على رحيل الأحبة، فالأطلال مُعادل لأنا مُهدّمة والحنين الذي يؤرّق الشّاعر هو البوتقة التي يُحاول فيها صهر تلك الأنا لإعادة تشكيلها، ويردّها إلى مشكاة النّور ومورد الحُب الأبدي في قصيدته "يا يثرب النّور" التي يمدح فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم واضعا "أناهُ" بكل عمره وذنوبه وتأملاته ورغباته في حالة استنفار لذلك المديح الذي اتكأ عليه الشّاعر مدعاةً لإذابة الأنا الضيقة المأزومة الظامئة في أنا رحبة ريانة، يقول :
اشتقتُ تكتحلُ العينان بعض ثرى
يا يثرب النور إني لو أراكِ أرى
خمسون عاما تجرّ المعصيات دمي
إلى غيابةِ أسر، خاب من أُسرا
تعثّرت ناقتي واثّاقلت قدمي
فرط الذنوب، أقيلوا ذنب من عثرا
صلوا على سيد السادات في نسبٍ
في الغار أميّكم باسم الإله قرا
صليتُ في ظمأ أروى الندى ظمئي
صليت في الرمل رملي عانق المطرا
صليت والحلق مر همتُ في عسل
صليت والدّرب شوك فانتشى شجرا
تبدو الأنا هُنا أكثر ثباتا واستقرار في مقام المديح الذي تأتيه الأنا مُشرعة الأمل غير متحرّجة من الآثام يقينا في كرم الكفّ التي ستروي ظمأ الرّوح.